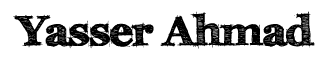يطل العجوز في وجهي مليا وكأنه يستعيد شيء ما من ذاكرة مشوشة. تحيرني تطلعاته، وأفتش أنا أيضا عما يمكنني تذكره. على طرفي الطاولة، نجلس مثل أثنين من المقامرين يلعبان النرد مع الذكريات، وكل منا ينتظر رمية الأخر. يهتف أخيراً
“ياااااه.. أنت؟!”
نعم، هو أنا. هل تذكرني؟ ما الذي لعله يتذكر؟ أقف على حافة ذاكرتي مفتشا عنه بين الوجوه والشخوص. وجهه القريب ظل غائما وراء نظارة معتمة وقبعة، بينما رنة صوته فقد ذهبت بعيدا في رأسي. هذا الصوت له وقعا مميزا. هل سيقول شيء أخر يذكرني به؟ لم يتكلم، بل أخرج علبة صغيرة من جيبه ومبسم سيجارة وقطارة. نظرة واحدة لتلك الأشياء التي خرجت من جعبته كانت كفيلة بتذكيري بشخصه. تلك كانت أيام بعيدة! كم من السنوات مرت؟ ربما عشرة؟ الذكريات هي لعبة حظ عشوائية، تنجح وتخيب، تكشف لحظات وتطمس أياما، وكأنها كتاب لا يمكنك تقليب صفحاته، بل ينفتح على أي صفحة يختارها لك.
تأتيه القهوة، فيخلع نظارته وكأنه يتأهب لحدث جلل ثم تمتد يده إلى قطارته ويضع بالفنجان قطرة واحدة بحرص. أتذكر هذا الأمر جيدا، أنها قطارة سحرية تحوي سائل يحلي قهوته، لا أحد يعرف ما هو، كما لا يمكن لأحد تفسير أيا من العجائب التي تخرج من جعبته. يفتح علبة صغيرة من العاج الأبيض، ويخرج منها حبة دواء قبل أن يبتلعها على مهل. رشفة من الإسبريسو، تتبعها لحظات يغمض فيها عينيه في وقار مهيب ثم ما يلبث أن يفتح عينيها على مهل كمن أفاق من حلم سريالي محير. تعود عينيه لتتفحصني بفضول ثم يفاجئني بحدث غريب. مد يده في سترته وأخرج علبة سجائر فضية مكسوة بالجلد وفتحها لي عارضا سيجارة. في قلب العلبة كانت هناك سجائر من ماركة جيتان الفرنسية، تلك السجائر القصيرة ذات اللون الأصفر التي اندثرت ولم يعد لها وجود، ولكن من غيره يأتي بأشياء نادرة الوجود. حاوي أنيق يملك في جعبته كل الأشياء الفريدة. يناولني الولاعة البرونزية فأسرح في تفاصيل النقوش الغريبة التي حفرت عليها، وألعب بها قليلا قبل أن أضغط على جانبها فتنفتح ويخرج اللهب. أسعل بعد نفس واحدا، فيضحك قائلا
“ثقيلة؟”
أرد وأنا أتفحص كعب السيجارة الصفراء القصيرة
“مفيهاش فلتر!”
يقول بالفرنسية ضاحكا
“وي سيلفو بليه”
أهتف قائلا
“حمدلله على السلامة يا دكتور!”
يهز رأسه ممتنا ويقول هامسا
“غريبه! ما توقعتش أنك لسه هنا”
أقول ضاحكا
“وأنا ما توقعتش أنك تسأل نفس السؤال المعتاد”
الدكتور سامر عدنان لا ينسى أبدا بأني أصغر رواد المكان. قبل سنوات طويلة، كان الأمر يثير فضولا ما عنده، فيسأل بعضا من العجائز عن سبب تواجدي في المقهى. لم تجمعني به أي أحاديث مباشرة من قبل، ولم يكن هناك ما يستدعي الصداقة، ولذلك كانت علاقتنا تبدأ وتنتهي بتحية مقتضبة، تأتي من خلف جريدة فرنسية يقرأها كل صباح. لم يكن الدكتور سامر شخصا عاديا، بل كان الجميع يتحدث عنه بإجلال ويقدرونه بشكل كبير. في أحيانا كثيرة كنت أرجح أن نأيه عن التحدث مع بعض الأشخاص بشكل مباشر ومنهم أنا، يعود إلى كونه رجل أرستقراطي متحفظ. لم أكن أعرفه جيدا، ولكني لم أنس تلك اللكنة الفرنسية في كلامه، ولا فضولي الجامح تجاه كل ما يخرج من جعبته من أحجية. لو كانت جيوبه تتكلم، لحكت حكايات لا تنتهي. أحاول أن أتذكر إن كان يدخن البايب، أم كانت سجائر في مبسم طويل؟ أتذكر أيضا أنه ذات يوما أخرج من جيبه سلسة تحوي مفاتيح ذات رؤوس مختلفة الشكل والحجم وكأنه يفتح بها صناديق أحجية، مما أستثار فضولي بشكل كبير وجعلني أهمس لبعض الجالسين متسائلا عن مهنة الرجل، هل هو ساحرا، أم تاجر أنتيكات؟ ضحكوا جميعا واستنكروا كيف لم أعرف من يكون وهو استشاري أمراض قلب مشهور ويملك عيادة في المبنى المجاور. كل تلك الذكريات كانت قد تاهت في ذاكرتي، ولكنها بدأت تعود على وقع هادئ وتحت تأثير تبغ قوي من سيجارة جيتان.
تلك كانت أول مرة يفتح معي حديثا، مما شجعني أن أسأله السؤال الذي حيرني دوما
“ممكن اسألك عن مقتنياتك؟”
يرد بدون أن يفكر ربما لأنه اعتاد مثل تلك الأسئلة
“ايه اللي عاجبك فيهم؟ علبة الدواء العاج اشتريتها من تاجر في لندن، قطعة فريدة من نوعها ومبطنة بحرير واهديت لأميرة هولندا سنة ١٨٠٧، القطرة كانت من مقتنيات الشاه اللي تركها في إيران بعد الثورة، لقيتها بالصدفة ضمن مجموعة اشتريتها من فرنسا وأنا بدرس هناك في السبعينات، أما علبة السجائر فمن بولندا، مصنوعة من الفضة وكانت من مقتنيات عائلة ارستقراطية في روسيا، كنت بحضر مؤتمر طبي هناك يمكن في أوائل الثمانيات واشتريتها. أيه كمان عجبك؟”
قلت حائرا
“ذوق رفيع!”
رد ممتنا
“ميرسي”
سألته بفضول
“أخر مرة شوفت حضرتك كانت من عشر سنين تقريبا. كنت مسافر؟ ولا غيرت المكان؟”
يبتسم ابتسامة رائقة وهو يقول
“كنت في إجازة، فاكانس. بس طولت هههه. في الحقيقة كنت عايش مع بنتي في كندا. في الأول قلت شهر أو شهرين، ولكن صحيت في يوم لقيتهم بقوا عشر سنين”
صمت لوهلة قبل أن يتابع قائلا
“أنا سعيد أنى قابلتك النهارده”
سعيدا بمقابلتي؟ ازدادت حيرتي. هذا الرجل لا يعرفني، بل كل ما أذكره عنه أنه كان يمرر أسئلة متوارية لرواد المقهى عن حقيقة أمري. لم يكن الأمر ساعتها يشكل هاجسا لي، فقد كنت قد اعتدت تلك الأمور خلال سنواتي الأولى في المقهى. لقد كنت أعرف أن الكثير من الرواد القدامى لم يتصالحوا مع وجود شابا حديث العهد بالمقهى وسطهم. ذلك المكان كان جزيرة منعزلة في وسط البلد، لا يدخلها سوى أعضاء قدامى مر على وجودهم عقود من الزمن. تغير الأمر تدريجيا خلال السنوات التي تلت حتى توارت الكثير من علامات الاستفهام التي كانت تلاحقني. تحول وجودي في المكان إلى حادث قد حدث وصار ماضيا، وتغيرت صفتي من زائر مريب إلى عضو دائم. الدكتور سامر عدنان كان قد تجاوز الخامسة والسبعين، ولكنه مازال يتمتع بصحة جيدة وهيئة مرتبة. عاد إلى مقهى بعد سنوات ليمنحني سيجارة من علبة أنيقة وابتسامة صافية. يحيرني هذا التصالح المفاجئ مع شخصي، واتسعت عيني عندما صرح لي بأنه سعيدا بالمقابلة. لاحظ الحيرة التي تملكتني فقال شيئا مفاجئا زاد من حيرتي
“عرفت أنك نشرت رواية”
من الذي أخبره؟ هؤلاء العجائز لا يكفون عن النميمة وتقصي الأنباء، تلك هي لعبتهم المفضلة مع الزمن البطيء في مقهى الإسبريسو. هل اكتشافه لصفتي ككاتب جعلته يتغير تجاهي؟ حتى هذا التفسير لم يكن مقنعا. انتظرته ليبوح بالمزيد ولم يخيب ظني، صمت ثم أفشى سره والابتسامة لا تفارقه
“اشتريت نسخة من أمازون وقريتها وأنا في كندا. عجبتني الرواية، مش مجاملة على فكرة. أنا متذوق جيد للأدب”
الآن فهمت السر، لقد أعجبته الرواية. في ذلك الصباح الهادئ، يحكي لي الدكتور سامر عن نفسه، ولأول مرة يكشف لي من يكون. من الغريب أن تقابل شخصا في حياتك وتنساه ثم يأتي يوما وبعد سنوات طويلة، تعاود اكتشافه.
“هل تعلم بأني أكتب أيضا؟” يقول الدكتور سامر
افتح عينيا مليا ولا أقاوم رغبتي في اللعب مع صناديق الحكايات فأقول
“أفضل الأماكن للاختفاء من الأشباح هو منزل الأشباح”
يرد مستغربا
“قصدك أيه؟”
لقد أنكشف لي وكان عليه استكشافه أكثر فقلت
“دكتور وكاتب؟”
يضحك ضحكة طويلة ثم يقول
“ياريت! كانت مجرد محاولات”
ينفتح الحوار ليجول بنا بين طرقات الذكريات. يحكي لي الدكتور سامر عدنان عن القصص التي ظل يكتبها بالفرنسية لمدة خمسة وعشرون عاما. الدكتور الذي تخرج من مدرسة الفرير ليلتحق بكلية الطب في باريس في أوائل الستينيات ويحصل بعده على الماجستير والدكتوراة، كان عليه العودة إلى القاهرة في أواخر السبعينات ليرث عيادة والده الذي كان هو أيضا طبيبا ذائع الصيت. يهمس وكأنه يخبرني بسر لا يجب أن يعمله أحد
“ظللت أكتب قصص قصيرة بالفرنسية سرا دون علم أحد لخمسة وعشرون عاما. كانت تنشرها لي مجلة فرنسية أدبية تحت أسم مستعار ولم يعلم أحد إلى الآن بهذا الأمر. أنا أنحدر من عائلة كلها أطباء مرموقين ويعتبرون الأدب والفن شيئا لا يليق بالعائلة“
أحاول أن تبدو ابتسامتي هادئة ووقورة، ولكني فاشلا تماما في التمثيل. فضولي جعله يصمت لبعض الوقت، وبدا وكأنه أكتفى بهذا القدر من الأسرار. أنهى فنجان القهوة ثم وقف مادا يده لي، صافحني بحرارة ثم سألني أن كنت أقبل دعوته لتناول الشاي في منزله. وافقت على الفور ودون تفكير، فأي كانت أسباب الدعوة، هناك حديث لم يكتمل وقصة تنتظرني. أنا شخصا يتبع القصص أينما كانت، وفضول الكاتب لا يهدأ ولا يستكين.
***

عندما ينفتح باب الشقة التي تقع بالطابق السابع المطل على نهر النيل بالزمالك، ستجد نفسك في شقة كبيرة ذات أثاث أرستقراطي قديم لا يوجد به أي شيء مثير للانتباه على عكس ما توقعت. يرحب بي بشدة ويربض على كفي باحترام ثم يقودني إلى غرفة مكتبه. ما أن دلفت غرفة المكتب حتى تغير كل شيء أمامي. أقف كالمشدوه وسط أرفف تحوي كتبا لا تنتهي. كتبا عن التاريخ والفلسفة ومؤلفات لكبار الروائيين وصحف قديمة وفجاءة تتوقف عيوني أمام دولاب يحتوي على الكنز. أقترب وأطل داخله مطالعا عشرات من العلب الصغيرة الفضية والخشبية القديمة التي تعلوها نقشات غريبة. الدولاب يحتوي على أرفف مكسوة بالقطيفة الزرقاء الداكنة وكل رف مخصص لمجموعات ما مختلفة من الساعات القديمة وأزرار قمصان والولاعات والأقلام والعديد من المقتنيات الغريبة التي لم أفقه ماهيتها أو استخداماتها. كل المقتنيات غريبة بشكل محير يفوق الوصف، ولا توجد بينها مقتنيات ذهبية أو أحجارا ثمينة، أنها مقتنيات فنان وليس جامع تحف.
“هذه مجموعتي الخاصة. كلها نادرة ومفيش قطعة ليها مثيل”
أسئلة وعيني تجوب محتويات الدولاب مندهشا
“أكيد كلفتك ثروة!”
يبتسم طويلا قبل أن يفتح الدولاب ويخرج منه علبة صغيرة ليضعها في يدي ثم يقول
“علبة تبغ صنعت من الفضة في الأرجنتين من حوالي قرنين وكانت ملك تاجر أسباني. دي ليها ذكريات عزيزة على قلبي. كانت أول مقتنياتي وأنا في الجامعة في باريس وكانت هدية. أنا مش بشتري من مزادات ولا بجمع انتيكات علشان ليها قيمة تاريخية، انا مش جامع انتيكات“
أقول متسائلا والحيرة تتملكني
“مش مصدق!”
يضحك قائلا
“محدش بيصدق الموضوع دهوه! أنا فعلا مش بفهم في الأنتيكات. السر في تلك العلبة اللي في أيدك”
أقول مستفهما
“الهدية!”
يذهب ليستريح على المقعد وراء مكتبه ثم يتابع الحكي قائلا
“سيلين، كانت قصة حبي. هي اللي كانت غاوية الانتيكات. العلبة دي كانت هدية منها علشان احط فيها تبغ البايب بتاعي. لاحظت اهتمامي بتفاصيل زي حبي لشكل فناجين معين، أو أنواع من العلب المنقوشة، أو حبي بشكل عام للأعمال الفنية النادرة والمختلفة. في كل مرة كنا بنشتري حاجة غريبة ومختلفة لاستخداماتي الحياتية. استمرت الهواية دي مع الوقت، وهوا ده سبب اللي ورا المقتنيات دي كلها”
اللغز إذا هو سيلين؟ أمسك طرف الخيط وأمضى خلف القصة وأنا أسأله
“وأيه حصل لسيلين”
يرنو نحو أرفف الكتب لبعض الوقت وقد بدا الحزن يتملكه. يحكي على مهل عن فتاة أحبها خلال دراسته في فرنسا، ولكنها كانت متزوجة من رجل أخر. لم تكن علاقتهم لتنجح وكان عليه العودة للقاهرة. فرقتهم دروب الحياة، ولكن ظل هناك خيط رفيع يجمعهما. كتب لها قصص حب بالفرنسية على مدار السنوات. لم يعلم أحد قط بالاسم المستعار سواها، هي التي كانت تقرأ تلك القصص وتعرف كاتبها الذي ظل مجهولا للجميع. الدكتور الذي يعرفه الجميع كطبيب مرموق وذائع الصيت، كان كاتبا لمدة خمسة وعشرين عاما، يكتب قصصه لقارئ واحد فقط. يكتب له كل حكايته.
ناولني قدحا من القهوة ثم قال وهو سارحا
“أيه اللي خالك قررت أنك تكون كاتب؟“
داهمني السؤال على حين غرة ولم أجد أجابه أستطيع طرحها عليه. بعد حيرة امتدت لدقائق قررت أن أقول له
“في الحقيقة معنديش سبب. يمكن لأن أفضل أوقاتي في الحياة هي اللي بأقضيها وأنا بكتب”
هز رأسه متفهما ويتطلع نحو كتبه ثم قال
“أنا قضيت حياتي أعمل في مهنة الطب وأربي أبنائي، بس كان عندي دائما هاجس بأن عندي رسائل محتاج أكتبها في شكل قصص. في البداية كانت كلها لسيلين، ولكن بعد ما كتبت كتير، أكتشف ان عندي رسائل للعالم. فقداني لسيلين، كان أول شيء مفقود في حياتي، وخلق عندي إحساس دائم بالفقدان، أحساس بأن في داخلي شخصا أخر مفقود، وهو أنا. الكتابة كانت بتخليني أقابل هذا الشخص، شخص كان بيتكلم بالفرنسي، وعنده عوالم مختلفة، وبيحب أشياء مختلفة، وأحيانا حتى مكانش يعرف شخصي العادي ولا مهنتي ولا حتى أسماء أولادي. ولكنه كان فاهم أيه اللي ناقصني”
على مدار ثلاث سنوات تلت، كنت أقبل الدكتور سامر عدنان في المقهى بشكل متقطع، ولكن نظرتي له كانت قد تغيرت بشكل جذري. عندما مات كان يأتيني أحيانا في الحلم، ولكنه كان يتحدث لي بالفرنسية ولم يقل شيئا بالعربية.
من حكايات مقهى الإسبريسو.
ياسر أحمد